
 للتسجيل اضغط هـنـا
للتسجيل اضغط هـنـا
|
|
|
أنظمة الموقع |
|
تداول في الإعلام |
|
للإعلان لديـنا |
|
راسلنا |
|
التسجيل |
|
طلب كود تنشيط العضوية |
|
تنشيط العضوية |
|
استعادة كلمة المرور |
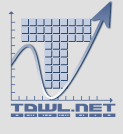 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||
|
|
#1 |
|
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 44
|
جاء في التقرير السنوي لنشاط سوق الأسهم السعودية ما نصه: «بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2003م (589.93) مليار ريال، وذلك بارتفاع نسبته (110.14%) مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية العام السابق 2002م عندما بلغت (280.73) مليار ريال. أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2003م فقد بلغت نحو (596.5) مليار ريال، مقابل (134) مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق 2002م، محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت (346%). حكم تداول أسهم الشركات التي تقترض أو تودع بالربا جاء في التقرير السنوي لنشاط سوق الأسهم السعودية ما نصه: «بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2003م (589.93) مليار ريال، وذلك بارتفاع نسبته (110.14%) مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية العام السابق 2002م عندما بلغت (280.73) مليار ريال. أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2003م فقد بلغت نحو (596.5) مليار ريال، مقابل (134) مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق 2002م، محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت (346%). أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2003م فقد بلغت نحو (5.6) مليار سهم مقابل (1.7) مليار سهم لنفس الفترة من العام السابق 2002م، محققة بذلك نسبة ارتفاع مقدارها (221%). أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2003م، فقد بلغ نحو (3.76) مليون صفقة مقابل (1.03) مليون صفقة لنفس الفترة من عام 2002م محققة بذلك نسبة ارتفاع مقدارها (246%)»(1). تأمل معي أخي القارئ هذه الأرقام الخيالية، والقفزات الهائلة في نسب القيم السوقية وعدد الأسهم المتداولة والصفقات المبرمة، إنها لتدل على أن السوق المالية السعودية مقبلة على مزيد من الاستثمار في الأوراق المالية، وما زال الأمر في بداية الطريق، ومن المتوقع أن يتم افتتاح سوق «بورصة» سعودية يتم فيها إجراء عدد من العقود المالية المتنوعة، كما هو الحال في الأسواق العالمية. إن هذه الأرقام الناطقة في التقرير السابق تدعونا لقراءة قوائم المراكز المالية لهذه الشركات المتداولة أسهمها في السوق لمعرفة هل هذه الشركات قائمة على معاملات مباحة خالصة من المحرم، أما أنها تزاول المحرم في معاملاتها؟ وإن كانت الثانية فهل نسبة المحرم كثيرة أم قليلة؟ وما هو المحرم الذي تمارسه: هل هو الإيداع بفوائد، أم أنها تقترض بفوائد، أم أنها تستثمر جزءاً من أموالها في شركات محرمة؟ ومما يدعونا أيضاً لقراءة قوائم هذه الشركات الأسئلة الكثيرة التي ترد إلى طلبة العلم من قِبَل المساهمين مثل: - ما هي الشركات التي يباح المساهمة فيها؟ - كيف يمكن أن أتخلص من المحرم إذا كانت الشركة تتعامل بالمحرم؟ - أنا لا أستثمر بل أتاجر؛ فكيف أتخلص من المحرم؟ هذه الأسئلة وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على أن نسبة عظمى ممن يساهم في هذه الشركات يتوق إلى الحلال، ولا يريد أن يطعم من يعول الحرام. ولهذا قام الباحث بإجراء دراسة علمية لـ (16) شركة من شركات السوق السعودي، وكان الهدف من الدراسة معرفة المعاملات المالية المحرمة التي تجريها الشركات، وقد نشرت هذه الدراسة في موقع الإسلام اليوم، وقد خلص الباحث إلى ما يلي: أن الشركات المساهمة تنقسم من حيث طبيعة عملها: هل هو مباح أو حرام؟ إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما كان عملها مباحاً بالكامل، أي لا تزاول أي عمل محرم، وهذا مثل البنوك الإسلامية الجادة في أسلمة معاملاتها، وبعض الشركات؛ إذ توفرت الشروط السابق ذكرها أثناء دراسة قوائم هذه الشركات. القسم الثاني: ما كان عملها محرماً بالكامل أو بالأغلب، وهذه مثل البنوك الربوية. القسم الثالث: ما كان عملها في الأصل مباحاً، ولكنها تتعامل بالمحرم من إيداع بفوائد أو تقترض وتقرض بفوائد، أو تستثمر أموالها بمعاملات محرمة قطعاً كالسندات، وهذا القسم يمثل أكثر شركات السوق، وهذه الشركات تتفاوت فيما بينها ما بين مقل ومكثر في تعاملها بالمحرم. فما حكم هذه الأنواع الثلاثة من الشركات؟ أما النوع الأول فلا إشكال في إباحته. والنوع الثاني كذلك لا إشكال في حرمته. وأما النوع الثالث فقد اختلف فيه العلماء المعاصرون على أربعة أقوال: القول الأول: الجواز بشروط. القول الثاني: الجواز في شركات القطاع العام والتحريم في غيرها. القول الثالث: أن ذلك يرجع إلى نية المساهم؛ فإن كان بقصد المتاجرة فإنه يجوز مطلقاً، وإن كان بقصد الاستثمار فيحرم. القول الرابع: التحريم مطلقاً. وقبل أن نذكر هذه الأقوال وأدلتها بالتفصيل يحسن بنا ذكر توطئة كمدخل لهذه المسألة النازلة: ü توطئة: نشاط الشركة ـ كما سبق بيانه ـ لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى: أن يكون جميع نشاط الشركة محرماً: والمقصود بهذه الحال أن يكون جل نشاط الشركة المساهمة في أمور محرمة. ويدخل في هذه الحال: 1 - الشركات التي تتاجر بالخمور أو المخدرات أو القمار. 2 - المصارف الربوية بشتى أنواعها؛ لأن جل نشاطها في التمويل بفائدة. 3 - شركات التأمين التجاري. 4 - شركات الإعلام الهابط، أو الإعلام المحارب للعقائد والمبادئ الإسلامية. «ولا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها»(1)؛ لأن من شرط صحة البيع أن يكون المبيع مباحاً، وهذه الأسهم محرمة. الحال الثانية: أن يكون جميع نشاط الشركة مباحاً: وهي الشركات التي تقع كل عملياتها في دائرة الحلال؛ حيث يكون رأس المال حلالاً، وتتعامل في الأنشطة المباحة، وينص نظامها وعقدها التأسيسي على أنها تتعامل في حدود الحلال، ولا تتعامل بالربا إقراضـاً أو اقتراضاً، ولا تتضمن امتيازاً خاصاً أو ضماناً ماليـاً لبعض دون بعض. فهذا النوع من أسهم الشركات ـمهما كانت تجارية أو صناعية أو زراعية ـ لا خلاف في جواز إنشائها والاكتتاب بهاوبيعها وشرائها. ويمكن أن نمثل لهذا النوع بالمصارف الإسلامية التي ثبتت جديتها في أسلمة أعمالها المصرفية كلها. الحال الثالثة: أن يكون أصل نشاط الشركة مباحاً، ولكن تتعامل ببعض الأنشطة المحرمة: ويقصد بها تلك الشركات التي لا يغلب على استثماراتها أنها في أمور محرمة، وإنما تنتج سلعاً وخدمات مشروعة، ولكن وجودها في بيئة رأسمالية قد يؤدي إلى أن تمول عملياتها عن طريق الاقتراض الربوي أو توظف سيولتها الفائضة توظيفاً ربوياً قصير الأجل. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون اختلافاً كبيراً، وقبل أن نبدأ في ذكر الأقوال في هذا النوع من الشركات يحسن بنا أن نحرر محل النزاع في هذه المسألة: ü تحرير محل النزاع: لا خلاف بين العلماء المعاصرين على الأمور التالية: 1 - أن المساهمةَ في الشركات التي يغلب عليها المتاجرة بالأنشطة المحرمة محرمةٌ، ولا تجوز لما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان. 2 - وأن من يباشر إجراء العقود المحرمة بالشركة ـ كأعضاء مجلس الإدارة الراضين بذلك ـ يكون عملهم محرماً، قلّت نسبة الحرام في الشركة أم كثرت. 3 - وأن الاشتراك في تأسيس شركات يكون من خطة عملها أن تتعامل في جملة معاملاتها بالعقود المحرمة، أو كان منصوصاً في نظامها على جواز ذلك؛ فإن هذا الاشتراك محرم. 4 - وأن المساهم لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يدخل في ماله كسب الجزء المحرم من السهم، بل يجب عليه إخراجه والتخلص منه، حتى على القول بجواز مساهمته. واختلفوا في حكم المساهمة في الشركات المشروعة من حيث الأصل، لكنها تتعامل في بعض معاملاتها بالأنشطة المحرمة، أو تقترض أو تودع بالفوائد على أربعة أقوال: القول الأول: الجواز. وممن ذهب إلى هذا القول: الهيئة الشرعية لشركة الراجحي(1)، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني(2)، والمستشار الشرعي لدلة البركه(3)، وندوة البركة السادسة (4)، وعدد من العلماء المعاصرين(5). وقد اشترط أصحاب هذا القول شروطاً إذا توفرت جاز تداول أسهم هذا النوع من الشركات، وإذا تخلف منها شرط لم يجز، ومنها: ما جاء في قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية رقم (485): «يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من الشركات المساهمة الضوابط الآتية: 1 - إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك. 2 - ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل (25%) من إجمالي موجودات الشركة؛ علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه. 3 - ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5%) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية، أم عن ممارسة نشاط محرم، أم عن تملك المحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط. 4 - ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم ـ استثماراً كان أو تملكاً لمحرم ـ نسبة (15%) من إجمالي موجودات الشركة. والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد، وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء». وذهبت الهيئة الشرعية لدلةالبركة إلى التفريق بين الأنشطة المحرمة التي تزاولها الشركة: فإن كان أصل نشاطها مباحاً، ولكنها تتعامل بجزء من رأس مالها مثلاً بتجارة الخمور، أو إدارة صالات القمار، ونحوها من الأنشطة المحرمة، فلا يجوز تملك أسهمها ولا تداولها ببيع أو شراء. أما إن كانت تودع أموالها في البنوك الربوية، وتأخذ على ذلك فوائد، أو أنها تقترض من البنوك الربوية، مهما كان الدافع للاقتراض؛ فإنه في هذه الحالة يجوز تملك أسهمها بشرط احتساب النسبة الربوية وصرفها في أوجه الخير(6). واتفق المجيزون على أنه يجب على المساهم في هذه الحال أن يتحرى مقدار ما دخل على عائدات أسهمه من الإيرادات المحرمة، وذلك من واقع القوائم المالية للشركة، فيتخلص منها بتوزيعها على أوجه البر، دون أن ينتفع بها أي منفعة، ولا أن يحتسبها من زكاته، ولا يعتبرها صدقة من حُرّ ماله، ولا أن يدفع بها ضريبة حكومية، ولو كانت من الضرائب الظالمة؛ لأن كل ذلك انتفاع بذلك العنصر الحرام من عائدات أسهمه(1). ويمكن أن يستدل لهم بالأدلة الآتية(2): الدليل الأول: ما روى زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «رخص في العرايا: أن تباع بخرصها كيلاً» متفق عليه(3). وجه الدلالة منه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة، كما جاء في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعاماً، نهى عن ذلك كله» متفق عليه(4). ثم إنه ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه رخص في العرايا يبتاعها أهلها بخَرْصها تمراً، فيجوز ابتياع الربوي هنا بخرصه، وأقام الخَرْصَ عند الحاجة مقام الكيل. قال شيخ الإسلام ابنتيمية: «لما نهاهم عن المزابنة لما فيها من نوع ربا، أو مخاطرة فيها ضرر أباحها لهمفي العرايا للحاجة؛ لأن ضرر المنع من ذلك أشد»(5). وقال أيضاً: «ويلحق بالعرايا ما كان في معناها؛ لعموم الحاجة إلى ذلك»(6). وقال أيضاً: «يجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها، كما يجوز بيع العرايا خرصاً بالتمر»(7). وعليه: «فإن الشركات المساهمة التي ظهرت في العصور الحديثة نتيجة لتطور الحياة المعاصرة ومنجزاتها العلمية، وظروفها الاقتصادية، وتأمين المرافق الكبرى كالكهرباء وشبكات المياه والهاتف والنقل، واستثمار الثروات الطبيعية المختلفة على النطاق المجدي اقتصادياً، كل ذلك يجعل تأسيس الشركات المساهمة حاجة حيوية عامة. وهذا يستلزم جواز تأسيس هذا النوع من الشركات التي أصل نشاطها حلال لكن تتعامل بالربا للحاجة العامة، فيصبح امتلاك أسهمها للاستثمار وأخذ أرباحها حاجة عامة أيضاً، ولا سيما بالنسبة إلى صغار المدخرين وأموال الأيتام والأرامل وسائر العاجزين عن استثمار ما لديهم من وفر ولا يكفي ما لديهم لمشروع تجاري، أو شراء عقار واستغلاله»(8). وقال الشيخ ابن منيع ـ حفظه الله ـ: «إن حاجة الناس تقتضي الإسهام في هذه الشركات الاستثمارية لاستثمار مدخراتهم فيما لا يستطيعون الاستقلال بالاستثمار فيه، كما أن حاجة الدولة تقتضي توجيه الثروة الشعبية إلى استخدامها فيما يعود على البلاد والعباد بالرفاهية والرخاء»(9). وعليه تقاس مسألة الإسهام بشركات تتعامل بالربا بشرط أن يكون أصل تعاملها بالحلال، على مسألة العرايا، كما قال شيخ الإسلام: «ويلحق بالعرايا ما كان في معناها لعموم الحاجة إلى ذلك»(10). ولهذا يرى هؤلاء العلماء: أن الإسهام في هذه الشركات يلبي حاجة عامة للأمة، دولة وأفراداً؛ فتنزل منزلة الضرورة الخاصة، فيجوز الإسهام فيها وإن كانت تتعامل بالربا إيداعاً واقتراضا(11). ويناقش هذا الاستدلال بما يلي: أولاً: أن قياس هذه الشركات على مسألة العرايا قياس مع الفارق من وجهين: الوجه الأول: أن الربا الذي تقوم به هذه الشركات هو من ربا الديون وهو ربا الجاهلية الذي نز ل القرآن بتحريمه؛ فهو محرم تحريم مقاصد؛ فلا يباح بحال إلا عند الضرورة المؤدية للهلاك كالمضطر لأكل الميتة، وأما الربا الذي في العرايا فهو من ربا الفضل، وهذا تحريمه تحريم وسائل، فيباح عند الحاجة(12). الوجه الثاني: أن أصل القياس على الرخص أمر مختلف فيه؛ فالحنابلة والحنفية وقول لدى المالكية لا يرون القياس على الرخص، ولهذا لم يقيسوا على ثمر النخل غيره، فاقتصروا على مورد النص، ولم يروا اطِّراد الحكم في الزبيب والزرع(13). ثانياً: وأما دعوى أن الإسهام في هذا النوع من الشركات يجوز من باب أنها من الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة الخاصة، فلا يسلم بذلك لما يلي: 1 - أنها لم تتعين طريقاً للكسب؛ إذ يوجد طرق أخرى من الكسب المشروع الحلال تغني عنها، ومن ادعى أن الحـرام عـم الأرض بحيث لا يوجد طريق للكسب المشروع يغني عن المشبوه فعليه الدليل(1). 2 - وعلى فرض وجود الحاجة؛ فإن من شروطها التي توجب تدابير استثنائية من الأحكام العامة أن تكون عامة لجميع الأمة، وليست هناك حاجة لعموم الأمة لأسهم الشركات التي تتعامل بالربا، ونسبة المستثمرين في الأسهم من عامة الناس أقل بكثير من غير المستثمرين بها. 3 - وإن من شروط اعتبار الحاجة أن لا تصادم نصاً، وهذا الشرط منتفٍ هنا؛ إذ إن النصوص متوافرة على تحريم الربا قليله وكثيره(2). 4 - وإن من شروط تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة الخاصة أن يقطع بارتفاع الحاجة بارتكاب المحظور، وفي الاستثمار بالأسهم قد يسهم الفرد في شركة تتعامل بالربا فيخسر فتزداد حاجته، أو لا يربح فتبقى حاجته(3). 5 - وإن من شروط تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة الخاصة أن تقدر الحاجة بقدرها؛ فإذا كانت الضرورة تقدر بقدرها؛ فما بالك بالحاجة التي هي أدنى من الضرورة؟ فهل يسوغ القول بأن تتعدى قدرها إلى أن نجعلها تشريعاً عاماً؟(4). 6 - ولو صح العمل بمقتضى قاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة للزم من ذلك القول جواز الاستثمار في السندات دفعاً للضرورة(5). 7 - وأيضاً للزم من ذلك فتح باب المحرمات بحجة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة؛ فهذه القاعدة قد تصبح محل استغلال، بل حجة في الخروج من الحرمة إلى الإباحة لدى كثير من المتفقهين المسايرين للتيارات المعاصرة؛ فالاستناد إليها في تحليل المحرم دائماً مع وجود بدائل وحلول شرعية أخرى يمكن الأخذ بها ليس من قبيل الرجوع إلى التشريع المقرر، بل يكاد يكون نابعاً من اتباع الهوى وإرضاء النفوس المريضة، والانقياد مع نزوات النفس. 8 - وأخيراً: لو فرضنا أن الاستثمار في الأسهم يحقق حاجة ومصلحة للبلد؛ فما القول في الاستثمار في الأسهم العالمية؟ والتي أصبحت تفوق في نفوذها وسيطرتها سوق الأسهم المحلية؟ «ويكفي أن نعرف أن استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية في عــام 1998م لم تتجــاوز (1,3) مليار ريال، وهــي لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من حجم السوق الذي بلغ في العام ذاته (24,38) مليار ريال، في حين بلغت استثمارات الصناديق في الأسواق العالمية (9,8) مليار ريال، ولغة الأرقام هذه تعطي دلالة واضحة على التدفقات الضخمة الخارجة من البلد والتي تنعم بها الشركات الأجنبية، وتصنع بها الرفاهية في بلادها، كل ذلك تسوِّق له الصناديق متذرعةً بأنها لا تساهم في شركات الخمور والقمار وغير ذلك؛ فهل يكفي ذلك لاستباحة الفوائد بحجة أنها تحقق حاجة ملحة للبلد؟»(6). الدليل الثاني: ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه(7). وجه الاستدلال: أن الحديث دل على جواز بيعالعبد مع ماله بثمن نقدي دون مراعاة لشروط الصرف؛ لأن المال الذي مع العبد تابع لامقصود. وعلى ذلك: «فهذا النوع من الأسهم وإن كان فيه نسبة بسيطة من الحرام لكنها جاءت تبعاً، وليست أصلاً مقصوداً بالتملك والتصرف»(8). ومن هذا الحديث أخذ العلماء قاعدة عامة وهي: «يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً». ولهذه القاعدة تطبيقات متعددة منها: جواز بيع الحامل، والدار مع الجهل بأساسات الحيطان وغير ذلك(9). «فيمكن اعتبار بيع سهم ـ من هذا النوع ـ من جزئيات هذه القاعدة»(10). نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن الحديث ورد في مسألة منصوص أو مجمع على حرمتها استقلالاً وجوازها تبعاً، وهذا بخلاف ما معنا؛ فإن المحتج بهذا الدليل يريد أنه إذا حرم استقلالاً يجوز الاجتهاد في حله تبعاً، وليس هــذا الذي عنــاه الفقهــاء مــن الحديث، لا سيما في باب الربا المقطوع بتحريمه وضرره(11). الوجه الثاني: بأن التبع الذي يغتفر مما كان أصله المنع يشترط فيه أن يكون غير مقصود، أما هنا فإن الإيداع أو الاقتراض بفوائد مقصود في عمل الشركة، ولذا تلحظ إصرار المجالس الإدارية للشركات على هذا العمل مع علمهم بتحريمه(1). الوجه الثالث: أن قياس تملك الأسهم على تملك العبد ونحوه قياس مع الفارق؛ فإن المحظور في تملك العبد هو في البيع نفسه لا في العبد، بينما في السهم يظل التحريم ملازماً لملكية السهم حتى بعد العقد، فتعاطي العقود المحرمة سيظل باقياً حتى بعد امتلاك السهم، ويد المساهم هي يد شريك؛ فكون الشركة أكثر أعمالها مباحة لا يبيح لها ممارسة قليل الحرام، ولهذا لم يجوِّز أهل العلم - القائلون بجواز بيع العبد بماله ـ أن يستثمر الشريك ماله بأمور محرمة ولو كانت يسيرة غير مقصودة(2). ونوقش استدلالهم بقاعدة (يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً) بما يلي: أولاً: أن هذه القاعدة معارَضة بأدلة وقواعد قد تكون أقوى منها دلالة في هذا الباب؛ فمن ذلك: 1 - ما ثبت في مسلم من حديث فضالة بـن عبيد ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «لا تباع حتى تُفَصَّلَ»(3). فلم يتساهل النبي -صلى الله عليه وسلم- في التابع الذي مع الربوي، مما يبين أن الربا قليله وكثيره حرام بخلاف غيره من المحظورات كالغرر ونحوه؛ فقد يتسامح في قليلها. 2 - قاعدة: «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام». 3 - قاعدة: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح». ثانياً: أن القواعد الفقهية ليست من الأدلة الشرعية المتفق عليها أو المختلف فيها التي نص عليها علماء الفقه والأصول، فلا يصح الاحتجاج بها(4). الدليل الثالث: الاسـتدلال بقاعــدة: «اختلاط الجــزء المحـرم بالكثير المباح لا يصـيِّر المجمـوع حرامـاً». وقاعدة: «للأكثر حكم الكل». ومفاد هاتين القاعدتين أن اليسير المحرم إذا كان مغموراً في الكثير المباح فإنه لا يؤثر في صحة التصرفات الشرعية من بيع وشراء وإجارة وغير ذلك. والأصل في ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعامل اليهود بيعاً وشراءً ورهناً وقرضاً مع أن الله وصفهم بأكل السحت والربا وأكل أموال الناس بالباطل. وقد ذكر العلماء لهاتين القاعدتين تطبيقات متعددة في أبواب الطهارة، والعبادات، والمعاملات والصيد والأطعمة واللباس كالحرير، وغيرها(5)؛ فمن ذلك: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: «الحرام إذا اختلط بالحلال فهذا نوعان: أحدهما: أن يكون محرَّماً لعينه كالميتة، فإذا اشتبه المُذكّى بالميتة حُرِّما جميعاً. الثاني: ما حرم لكونه غصباً، والمقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر؛ فهذا إذا اشتبـه واختلط بغيره لم يحرم الجميع، بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه»(6). وسئل عن معاملة من كان غالب أموالهم حراماً، فقال: «إذا كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة، وإن كان الحرام هو الأغلب، قيل بحل المعاملة، وقيل: بل هي محرمة. فأما المتعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال، إلا أن يعرف الكره من وجه آخر، وذلك أنه إذا باع ألفاً بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط»(7). وبناءً على ذلك فإن «جزءاً يسيراً من أسهم الشركات التي هي موضوع بحثنا من هذا النوع حرام، والباقي منها وهو الكثير مباح»(8). أي فيكون الحكم للأكثر وهو المباح. ونوقش هذا الاستدلال من خمسة أوجه: الوجه الأول: لا يُسلّم بأن نسبة الربا في هذه الشركات قليلة جداً، لما يلي(9): 1 - ما توصل إليه الباحث من خلال دراسته لبعض الشركات في السوق من أن نسبة التعامل بالمحرم وصلت إلى 52%(10). 2 - أنه من الصعب إيجاد ضابط لذلك؛ فقد ترتفع نسبة الربا في ســـنة، وقد تهبط فــي أخـــرى، وما دامت الشـركة لا تتورع عن الربا فإن نسبة تورطها فيه تخضع لمعايير تجارية ونظريات اقتصادية. 3 - أن الشركات حديثة التأسيس التي لم تزاول نشاطها بعد قد ثبت من خلال الرجوع إلى ميزانياتها أنها تستثمر رأس مالها في الربا حتى يحين وقت توظيفه في مشروعها الأساسي، بل إن بعض هذه الشركات قد توزع أرباحاً للمساهمين وهي لم تزاول نشاطها بعد، وهذا يدل على أنها استخدمت أكثر رأس مالها في الربا. 4 - أن نظام الشركات يفرض على الشركات المساهمة أن تخصص جزءاً من ربحها سنوياً ليكون احتياطياً لها، وهذه النسبة تختلف باختلاف الأنظمة؛ ففي نظام الشركات السعودي تنص (م 15) منه على ما يلي: «تجنيب مجلس الإدارة كل سنة 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي النظامي، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال». وعلى هذا فإن هذه الشركات المساهمة التي لا تتورع عن الربا لو التزمت حرفية النظام فجنبت الاحتياطي لدى أحد المصارف، وأخذت عليه فائدة لأصبحت تستثمر ثلث مالها تقريباً في الربا وهي نسبة لا يستهان بها. الوجه الثاني: أن قياس المشاركة في شركات تتعامل بالربا على معاملة من اختلط ماله الحرام بالحلال قياس مع الفارق(1). ويظهر الفرق في ثلاثة أمور: 1 - أن معاملة من اختلط ماله بالحرام تُحمل على الجزء المباح من ماله؛ حملاً لتصرفات المسلمين على الصحة. أما المشاركة في شركات تتعامل بالربا فلا يمكن تصحيح الجزء المحرم؛ لأن المال المستثمر بالربا هو عين مال الإنسان؛ فلو ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- - وحاشاه من ذلك ـ وضع أموالاً عند اليهود لاستثمارها بطريق المشاركة، أو أن أحداً من أهل العلم استعمل القاعدتين في باب المشاركة كما في البيع لكان حجة في ذلك، ولكن كل ذلك لم يكن، بل جاء عنهم ما يفيد المنع كما سيأتي. 2 - أنه لو صح هذا القياس ـ أي قياس الشركة على المعاوضة ـ لجاز للإنسان أن يستثمر أمواله في الشركات ذات الأغراض المحرمة، قياساً على جواز المعاملة معها بالبيع والشراء، وهو أمر ممنوع بالاتفاق. 3 - أن مشـاركة من يتعامل بالربا فيها معنى الإعانة على الإثم، بخلاف التعامل معه بيعاً وشراءً واستئجاراً ونحو ذلك، فإن المشتري أو المستأجر يأخذ من المرابي ما يقابل عوضه المبذول. الوجه الثالث: أن هاتين القاعدتين مردودتان بقاعدة: «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام»، وقاعدة «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح». الوجه الرابع: أن إعطاء الكل حكم الأكثر ليس على إطلاقه؛ فالشراب المسكر محرم وإن كانت الخمرة التي فيه أقل من الماء، والنجاسة إذا غيرت لون الماء أو ريحه تنجس ولو كانت قليلة(2). الوجه الخامس: وما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز معاملة من اختلط ماله بالحرام لا يصح الاستشهاد به هنا لأمور: 1 - أن هذه النقول هي في حالة الاشتباه، والحالة التي نناقشها ليس فيها اشتباه، وإنما فيها علم وإقدام على شراء أسهم فيها حرام(3). 2 - ما ذكره شيخ الإسلام وغيره عن المحرم لكسبه إنما هو فيما إذا جاء الغاصب ونحوه بمال حرام فضمه إلى ماله الحلال وخلطه، فإن هذا الخلط لا يحرم ماله الحلال لا أن العقد الفاسد ـ كما في موضوعنا ـ يكون صحيحاً؛ فهو لم يحكم بتصحيح الغصب، ولا ذلك العقد الفاسد. وحينئذٍ إذا أراد الخلاص من الحرام يميز كلاً منهما عن الآخر، فيصرف كلاً منهما إلى مستحقه؛ فالمغصوب إلى المغصوب منه، والحلال يبقى عنده. وهذا الحكم متفق عليه؛ فلا يُحكم بحرمة جميع مال المســاهــم الذي اشــترك فـي الشــركة معتقداً أنهـا لا تـودع ولا تقرض بفوائد ربوية، ثم يتبين لـه مستقبلاً أنها تفعل ذلك، وإنما يقدر نصيب أسهمه من الفوائد الربوية ويخرجها منه، أو من ربحها؛ لأنها محرمة عليه، والباقي حلال له، لكن نقول: إن المساهم الذي يعلم أن الشركة تأخذ وتعطي فوائد ربوية يحرم عليه البقاء فيها، كالغاصب أو المتعامل بعقد فاسد يحرم عليه الاستمرار فيه؛ فهذا هو مراد أهل العلم فيما نقل عنهم(4). 3 - أن في معاملـة من في ماله حلال وحرام لا يجزم المتعامل معه بالبيـع والشـراء والاستئجار ونحو ذلك أن نصيبه وقع في الحرام قطعاً، بخلاف المساهم في الشركات التي تتعامل بالربا؛ فإنه بتملكه أسهماً في الشركة سيسهم قطعاً مع الشركاء فيما سيستقبلونه من أعمال تالية لتملك السهم؛ فإذا كانت هذه الأعمال محرمة؛ فبأي وجه يمكن تجويزها، ومن المعلوم أن السهم حصة شائعة في الشركة بجميع ما تشتمل عليه من أصول ثابتة أو منقولة أو حقوق أو أرباح ملوثة أو غير ذلك، ولا يمكن تمييز حصته عما عداه من الشركاء(5). 4 - على أنه قد ورد عن بعض السلف تحريم التعامل مع المرابي ونحوه، فقد سئل الإمام أحمد عن الذي يعامل بالربا، يؤكل عنده؟ قال: لا، «قد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله»(6)، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالوقوف عند الشبهة(7) ا. هـ. وللمقال بقية فيفي المقال السابق بين الكاتب أنه قام بإجراء دراسة علمية لست عشرة شركة من شركات السوق السعودي، وذكر أن الشركات المساهمة تنقسم من ناحية طبيعة عملها من حيث الحلال والحرام إلى ثلاثة أقسام، وأن نشاط الشركة لا يخلو عن ثلاث حالات: أن يكون جميع نشاط الشركة محرماً، أو يكون جميع نشاط الشركة مباحاً، أو يكون أصل نشاط الشركة مباحاً ولكن تتعامل ببعض الأنشطة المحرمة. وقد بين الأقوال المختلفة حول ذلك وناقشها، وفي هذا المقال يتم موضوعه..ـ البيان ـ [4 - على أنه قد ورد عن بعض السلف تحريم التعامل مع المرابي ونحوه، فقد سئل الإمام أحمد عن الذي يعامل بالربا، يؤكل عنده؟ قال: لا، «قد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله»(1)، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالوقوف عند الشبهة(2) ا. هـ](*). الدليل الرابع: الاستدلال بقاعدة «ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو». ولهذه القاعدة تطبيقات متعددة ذكرها الفقهاء، منها: العفو عن يسير رذاذ البول، ويسير طين شارع تحققت نجاسته، ونحو ذلك. ووجه الاستدلال بهذه القاعدة: أن أسهم الشركات التي تتعامل بشيء من الحرام لا يمكن الاحتراز منه، فهو معفو عنه(3). ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: الأول: لا يسلَّم بذلك؛ لأنه غير شاق، والاحتراز عنه ممكن؛ وذلك بعدم الدخول في هذا النوع من الشركات، فهو لن يجد من يجبره على الاشتراك فيها، لا سيما مع توسع فرص الاستثمار المباح في المجالات المتعددة، ومع انتشار المصارف الإسلامية في هذا الوقت، بعد أن كان المجال المصرفي إلى وقت قريب مقتصراً على المصارف الربوية. الثاني: وأما قولهم: (يعفى عما يعسر الاحتراز عنه) فإن هذا إذا كان بغير قصد؛ أما بقصد الدخول فإنه يعتمد على عدم التحرز عنه، فلا يعفى حينئذ(4). الدليل الخامس: الاستدلال بالمصلحة. ووجه ذلك: أن تملك الأسهم من قِبَل أهل الخير والصلاح المنكرين لهذه المعاملات فيـه مصلحة شرعية بالقضاء على تلك المعاملات عن طريق الدخول في المجالس الإدارية(5). ونوقش من وجهين: الوجه الأول: عدم التسليم بأن المشاركة في هذه الشركات من المصلحة، بل قد يكون المصلحة في عدم الاشتراك أكثر من مصلحة الاشتراك، ووجه ذلك: أن منع الاشتراك في هــذه الشـركات مع بيان سـبب المنع ـ وهو وقوع هذه الشركات في المعاملات المحرمة ـ من شأنه أن يجعل القائمين على هذه الشركات يبادرون مبادرة جادة إلى التخلص من هذه المعاملات المحرمة، وتوسيع التجارة المشروعة بأنواعها طلباً لاشتراك الناس ومساهماتهم(1). الوجه الثاني: ومع التسليم بوجود مصلحة في المشاركة؛ فهذه المصلحة غير معتبرة للأسباب الآتية: 1 - أن المصلحة إذا كانت مصادمــة للنص فهـي ملغاة، فلا عبرة بها(2). 2 - أن هذه المصلحة مظنونة، والمفسدة المترتبة على المساهمة محققة، والمفسدة المحققة مقدمة في الاعتبار على المصلحة المظنونة، كما هو معلوم من قواعد الشرع(3). 3 - أن هذا التعليل متوجه في حق كبار التجار، والشركات الإسلامية، الذين يرجى من مساهمتهم التغيير المباشر لنظام الشركة، أما آحاد الناس فإن هذا المقصـد إن صدق في بعضهم فهو غير موجود عند كثير منهم(4). مناقشة دعوى إمكانية التخلص من الكسب الحرام(5): بقي أن يقال: إن أصحاب القول الأول اشترطوا في جواز المشاركة بمثل هذه الشركات: أن يتخلص المساهم من الكسب المحرم. ومما يؤكد أن هذا الاشتراط افتراضي وليس واقعياً، أنه يستحيل تحديد مقدار الكسب المحرم من عوائد السهم. ونحن هنا في مقام لا يحتمل الظن والتخمين، بل لا بد من القطع واليقين. وإيجاب بعضهم ـ عند الجهل بالحرام ـ إخراج نصف ربح السهم أو ثلثه؛ فهم قالوا به من باب الاحتياط، وهو نافع في حالة وجود أرباح حقيقية للشركة من النشاط المباح، وهو أيضاً غير شاق من الناحية العملية، إلا أنه غير عملي ولا يفي بالغرض في صورتين: الأولى: عندما لا تحقق الشركة أرباحاً تذكر من مبيعاتها في بعض السنوات، فتبقى معتمدة في توزيعات الأرباح على فوائد الودائع، والسندات البنكية والأوراق قصيرة الأجل ذات الدخل الثابت. الثانية: كما أن بعض الشركات تقوم بتوزيع الأرباح قبل البدء بتشغيل منشآتها، وهذه الأرباح تحصلت عليها من إيداع رأس المال في البنوك. وعليه: إذا كان الأمر محتملاً فلا يكفي التقدير في هذه الحالة. أما تحديد مقدار الكسب الحرام، كما تفعله بعض الهيئات الشرعية، من أجل دقة التخلص من الحرام فهو متعذر؛ لأمور، منها: 1 - أن جميع المجيزين يفترضون أن الشركة تودع وتأخذ فوائد، فيوجبون على المساهم إخراج ما يقابل نصيب الودائع من الأرباح. فإذا كانت الشركة تقترض من البنوك لتمويل أعمالها، أو لإجراء توسعات رأسمالية ونحو ذلك؛ فما السبيل لتحديد ما يقابل هذه القروض من الأرباح؟ 2 - أن أغلب المستثمرين يشترون الأسهم بقصد الحصول على الأرباح الرأسمـالية، أي فرق السعر بين الشراء والبيع، ومن المتعذر في هذه الحالة تحديد مقدار الكسب الحرام، ولا سيما أن من العوامل المؤثرة على القيمة السوقية للسهم مدى قدرة الإدارة على الحصـول على التسهيلات والقروض البنكية. 3 - إذا خسرت الشركة؛ فماهو نصيب الكسب الحرام من هذه الخسارة؟ إذا علمنا أن إيرادات الودائع والسنداتثابتة، فهذا يعني أن الخسارة على من يريد التخلص من الربا ستكونمضاعفة. 4 - ومن المعتاد أن الشركة تستثمر جزءاً من أموالها في شركات تابعة أو شركات زميلة أو في صناديق استثمارية بالأسهم أو السندات، وقد تكون تلك الأسهم لشركات ذات أنشطة محرمة أو ذات أنشطة مباحة وتتعامل بالفوائد، وهكذا تمتد السلسلة إلى ما لا نهاية، ويصبح تحديد الحرام في هذه السلسلة من الشركات أشبه بالمستحيل. القول الثاني: التفريق بين شركات القطاع العام وغيرها، فيجوز في شركات القطاع العام، ويحرم في غيرها. وممن ذهب إلى هذا القول الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله تعالى(6). والمقصود بشركات القطاع العام: هي الشركات التي تملكها الدولة، أو تملك معظم أصولها، وتهيمن على إدارتها، ويملك الأفراد بعضها الآخر، مثل شركات الماء والحديد والكهرباء والاتصالات(7). وأما شركات القطاع الخاص: فهي الشركات التي يملكها الأفراد، ولم تكن الدولة طرفاً فيها. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة القول الأول وقد سبق ذكرها ومناقشتها. ويمكن أن يستدل لهم أيضاً بدليل خاص يؤيد ما ذهبوا إليه: وهو دليل مركب من حديثين: الحديث الأول: ما روى سمرة بن جندب «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»(1). الحديث الثاني: ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة»(2). وجه الدلالة منهما: أما الحديث الأول: ففيه نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مطلقاً. أما الحديث الثاني: فإنه يدل على إباحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وذلك لمصلحة الجهاد؛ فالجهاد فيه مصلحة عامة للأمة من حفظ أمنها وتقوية جانبها. فكل ما فيه مصلحة للأمة فإنه يجوز التعامل به وإن كان يلزم منه الوقوع في المحرم، كبيع الحيوان بالحيوان نسيئة لتجهيز جيش المسلمين. ومثل ذلك شركات القطاع العام؛ فهي تمثل ضرورة قائمة، وتكاليف هذه المشروعات مرتفعة جداً، وتحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة مما يعجز عنه كثير من الدول في عصرنا هذا لا سيما في الدول النامية، واليوم معظم الخدمات العامة في كثير من البلدان النامية تقوم على أساس الشركات المساهمة، وإذا قيل بمنع هذه الشركات لم تتحقق تلك الخدمات، ولا سبيل إلى الاستغناء عنها، وإلا بقي المجتمع متخلفاً في أهم المرافق الحيوية، بخلاف الشركات التجارية، فيمكن أن يستمر المجتمع بدونها. وعليه: يجوز الإسهام في مثل هذا النوع من الشركات وإن كانت تودع أموالها بفوائد أو تقترض بفوائد؛ لأنه إذا لم نساهم فيها بقيت الأمة متخلفة في أهم المرافق الحيوية الضرورية للمجتمع. ويناقش هذا الدليل بما يلي: أولاً: أن حديث سمرة ـ رضي الله عنه ضعيف ـ كما هو مبين في تخريجه. وعليه فلا يصح الاستدلال بحديث عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ على جواز الوقوع في المحرم من أجل المصلحة؛ لأن الحديث باق على أصل الإباحة في المعاملات. ثانياً: أن النهي في حديث سمرة محمول على أن تكون النسيئة من الطرفين في الثمن والمثمن، وهذا محرم بالإجماع، ويدخل في بيع الكالئ بالكالئ(3). وأجيب(4): أنه لا يحمل هذا على النسيئة من الجانبين من وجهين: 1 - لأن ذلك يستفاد بنهيه -صلى الله عليه وسلم- «عن بيع الكالئ بالكالئ»(5). 2 - ولأنه إذا قيل: باع فلان عبده بالحيوان نسيئةً؛ فإنما يفهم منه النسيئة في البدل خاصة، ومطلق الكلام محمول على ما يتفاهمه الناس. والذي يظهر للباحث أنحديث سمرة ـ رضي الله عنه ـ ضعيف؛ فلا يكون حجة في أصل المسألة؛ وعليه فيبقى حديثابن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ على إطلاقه، وأنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة،ولا يدخــل ذلك فـي الربا، ومـن ثَمَّ لا يكون فيه دليل لهم على جواز الإسهام فيشركات القطاع العام إذا كانت تتعامل بالربا. وأما دعوى الحاجة فقد سبق الجواب عنهاأثناء مناقشة القول الأول. ومما يُضعِف هذا القول ـ أعني التفريق بين شركات القطاع العام والخاص ـ أنه توجد شركات في القطاع الخاص ولا تملك الدولة منها شيئاً إطلاقاً؛ ومع ذلك فهي مهمة جداً، بل قد توازن في أهميتها شركات القطاع العام، كشركات الإسمنت والصناعات الأساسية كالحديد والشركات الطبية كالدوائية وغيرها من الشركات؛ فهل أصحاب هذا القول يُدخِلون هذه الشركات ضمن شركات القطاع العام أم لا تدخل في ذلك؟ فالتفريق بين الشركات تفريق بين المتماثلات، ومن علامات صحة القول اطِّراده، والظاهر أن هذا القول غير مطَّرد. فهل الضابط في ذلك كون الدولة تملك هذه الشركة؟ أم أن الشركة ضرورية للمجتمع؟ أما إن كان الضابط أن تكون الشركة ملكاً للدولة؛ فإن الدولة قد تمتلك شركات وهي ليست من الشركات الضرورية للمجتمع؛ فهل في هذه الحالة يجوز الإسهام فيها؟ وأما إن كان الضابط: أن الشركة تكون ضرورية للمجتمع فهذا غير مطَّرد، وتختلف أنظار الناس في كون هذه الشركة ضرورية أم لا، وما كان ضرورياً عند قوم قد لا يكون ضرورياً عند آخرين، والشريعة عامة للجميع لم تختص بقوم دون قوم. القول الثالث: الرجوع إلى نية المساهم؛ فإن كان يقصد المتاجرة بأسهم هذا النوع من الشركات فيجوز تداولها، وإن كان يقصد الاستثمار فلا يجوز. وممن ذهب إلى هذا القول الدكتور محمد المختار السلامي(1). واستدل الدكتور السلامي لقوله بما يلي: الدليل الأول: أن من يقصد نشاط الشركة وأرباحها، فإنه عندما يشتري السهم يصبح من الشركاء؛ فهو رضي عند الشراء بكل ما جاء في عقد التأسيس، ومنه عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في التعامل الذي هو قصده. وأما من يقصد المتاجرة بالسـهم فهو لم يقصـد نشاط الشركة ولا عملها، بل يقصد فارق السعر من تقلبات السهم في الأسواق(2). ويناقَش هذا الدليل بما يلي: أولاً: أن مشتري السهم بقصد المتاجرة أو الاستثمار كل منهما قد رضي عند الشراء بكل ما جاء في عقد التأسيس، ومنه عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، فلا وجه للتفريق بينهما. ثانياً: أنه يلزم على هذا التفريق أن من يشتري أسهم البنوك الربوية أو السندات المحرمة بقصد المتاجرة بها فهو جائز، وهذا لم يقل به أحد من العلماء المعتبرين. ثالثاً: ومما يضعف هذا التفريق: أنه لو حدث توزيع لبعض الأرباح أو خسارة للشركة، أثناء تربص حامل السهم لارتفاع قيمته، هل يكون هذا الربح حلالاً؟ فإن ألزمناه بالتخلص من نسبة المحرم فقد ساوى بذلك من قصد الاستثمار، وإن أبحنا له الربح كله، فهذا لم يقل به أحد من العلماء المجيزين للتعامل بمثل هذا النوع من الشركات، بل جميعهم متفقون على التخلص من نسبة المحرم في السهم. الدليل الثاني: أن مجمع الفقه الإسلامي تبعاً لذلك لم يسوِّ بينهما في الزكاة؛ فقد قرر أن الأسهم التي يقصد من تملكها الحصول على ربحها السنوي يزكي صاحبها الريع بعد دوران الحول من يوم قبضه. وأن الأسهم التي يقصد من تملكها التجارة تزكى زكـاة عروض التجارة(3). ويناقَش من وجهين: الأول: أن عدم تسوية المجمع بينهما في الزكاة نظراً لاختلاف حكم الزكاة بين عروض التجارة وأموال القنية لا لشيء آخر. الثاني: أن هذا الأمر ليس مجمَعاً عليه، وإن من العلماء من طرد الحكم في جميع الأسهم وأوجب فيها زكاة العروض مطلقاً، فليست هذه المسألة محل وفاق حتى نلتزم بها(4). القول الرابع: عدم الجواز مطلقاً. يرى جمهور العلماء المعاصرين، وعدد من الهيئات الشرعية تحريم المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحاً، إذا كانت تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة. فيحرم الاكتتاب بها، وبيعها وشراؤها وامتلاكها. وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكه، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله(5)، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي(6)، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي(7)، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني(8)، وعدد من الفقهاء المعاصرين(9). وأصدر مجمعان فقهيان مشهوران قرارين يقضيان بتحريم هذا النوع من الشركات، وهذان المجمعان يحويان ثلة من علماء العصر المعتبرين؛ فأما المجمع الأول فهو: المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص قراره هو: «ج: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربـا ونحـوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة»(10). وأما المجمع الثاني فهو: المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ونص قراره هو: «لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك»(11). استدل أصحاب هذا القول بما يلي: الدليل الأول: قول الله ـ تعالى ـ: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْـمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]، وقولـه ـ تعالى ـ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة: 278]، وقولـه -صلى الله عليه وسلم-: «ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع»(1). وعن جابر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»(2). ووجه الدلالة من هذه النصوص: أنها عامة في التحريم، فتشمل الربا قليله وكثيره. ووجه العموم يظهر فيما يلي: 1 - كلمة «الربا» في الآيتين معرَّفة بأل التي تفيد استغراق الجنس، فتعم. 2 - كلمة «كل» في حديث جابر من صيغ العموم. 3 - «آكل الربا» و «موكله» نكرتان مضافتان إلى معرفة، فتعمان. 4 - «الربا» في الحديث الأخير معرَّفة بأل، وهي من صيغ العموم، فيشمل الحديث كل آكل للربا أو موكل له، قلَّ الربا أو كثر. والربا الناتج عن اقتراض الشركات المساهمة أو إيداعها هو من ربا الجاهلية الذي جاء القرآن بتحريمه، وبينت حكمه هذه الأحاديث الشريفة؛ فكيف يسوغ لقائل بعد ذلك أن يقول: إن الربا إذا كان قليلاً ومغموساً في الحلال الكثير فهو جائز(3). * نوقش: بأن المستثمر لا يأخذ الربا؛ إذ يجب عليه فوراً التخلص من مقدار الكسب الحرام، وصرفه في وجوه البر(4). وأجيب عنه من أربعة أوجه: الوجه الأول: أنه وإن كان لا يأكل الربا فهو يؤكله؛ لأن الشركة تتمول بفوائد فتدفع الربا لجهات التمويل؛ فهو داخل في لعن النبي -صلى الله عليه وسلم-(5). الوجه الثاني: أن تقدير الحرام وإخراجه لا يبيح شراء أسهم هذا النوع من الشركات لأمرين: الأول: لأن محل العقد (وهو سهم الشركة التي تقترض بفوائد ربويه) مالٌ محرم بسبب ما اشتمل عليه من الربا. وبناءً عليه؛ فهذا العقد باطل على مذهب جمهور الفقهاء، وفاسد عند الحنفية؛ لأن العقود التي يدخلها الربا تكون فاسدة عندهم كبيع الدينار بالدينارين، فإذا زال المفسد وهو الدينار صح العقد. لكن الربا في الأسهم هذه لا يمكن فصله عن المبيع حتى يمكن إمضاء العقد في المباح ومنعه في الحرام، لاختلاط ذلك اختلاطاً يتعذر معه التمييز، ولأن الواقع أن بائع الأسهم يبيعها بجميع حقوقها، ولا يتم استثناء شيء من ذلك، ولذا فإن العقد باطل لم تترتب عليه آثاره، فمشتري السهم لم يمتلك السهم أصلاً حتى يتخلص من مكاسبه المحرمة(6). الثاني: ولأن هذا التقديـر مبنـي علـى الحَزْر والتخمين، ولا يستطيع أي محاسب مهما بلغ من العلم أن يصل إلى حساب قطعي. والتخمين لا يكفي في العقود الربوية؛ لأن التخمين لا يـؤدي إلى التسـاوي يقينـاً، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، بدليل تحريم المزابنة(7)، والمحاقلة(8)، وعلة تحريمهما عدم العلم بالتساوي لنشوفة أحدهما ورطوبة الآخر(9). الوجه الثالث: أن تقدير الحرام وإخراجه لا يكون توبة من الذنب الذي وقع فيه؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والعزم على ألا يعود، والندم على ما عمل، والذي دأبه أخذ الحرام ثم إخراجه لا يعد نادماً ولا عازماً على الإقلاع(10). قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ: «تستحيل التوبة مع مباشرة الذنب»(11). الوجه الرابع: أن التخلص من الربا قد يكون ظاهراً فيمن يريد الاستثمار، لكن من كان يتاجر بالسهم، وينظر إلى تقلب الأسعار، ولا ينتظر الربح الذي يعطى في نهاية السنة حتى يطهره من الربا، كيف يمكن أن يصنع؟ إن قلتم: إنه يبيع السهم ولا يلزم بالتخلص من عوائد الربا فما الفرق بينه وبين السندات والأسهم الربوية إذا كان قصده المتاجرة بها فقط؟ وإن قلتم: يلزمه التخلصمن عوائد الربا؛ فما هي القاعدة في ذلك وهو لم يحصل على أي ربح؟ ثم إن الشركة قدتخسر ولا توزع أرباحاً؛ فماذا يصنع؟ الدليل الثاني: قول الله ـ تعالى ـ: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ والْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]. وعن جابر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه». ووجه الدلالة من هذين النصين: أن الذي يساهم في الشركات التي تتعامل بالمحرمات مُعِين لها على الإثم، فيشمله النهي. الدليل الثالث: قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم، أشـد من سـت وثلاثين زنية»(12). ووجه الدلالة منه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عد أكل درهم واحد من الموبقات، ورتب عليه هذا الوعيد الشديد؛ فكيف بمن يضع المئين والآلاف من أمواله في المصارف الربوية؟ وإخراج قدر الحرام تخمين؛ فمن غير المستبعد أن يدخل ماله شيء من الحرام(13). الدليل الرابع: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(1). وجه الدلالة من الحديث: إن هذا الحديث حجة في إبطال جميع العقود المنهي عنها، وعدم وجود ثمرتها المترتبة عليها؛ فالنبي -صلى الله عليه وسلم- حكم في هذا الحديث بالرد وعدم القبول على كل مخالف للشرع، ومن المخالف كل بيع يدخله الربا وشراء أسهم شركات يدخل الربا في نشاطها مردود؛ لأنه منهي عنه بنص الحديث؛ لاشتمال الأسهم على الربا؛ ولأنه ليس عليه أمر النبي -صلى الله عليه وسلم-. الدليل الخامس: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم منه فائتوا منه ما استطعتم»(2). وجه الدلالة منه: أن المنهيات تجتنب على الإطلاق، ولهذا لم يتسامح الشرع في الإقدام على شيء منها، وخصوصاً الربا؛ لأنه من الكبائر. وأسهم الشركات التي يدخلها الربا من المنهيات، فتجتنب جميعها. الدليل السادس: أن شبهة الربا مفسدة للعقد ومحرمة له؛ كما في بيع المزابنة والمحاقلة؛ وذلك لاحتمال الربا، وقد أجمع الفقهاء على أنه يحرم بيع المحاقلة(3). ويرى جمهور الفقهاء أن عقد المزابنة والمحاقلة باطل، ويرى الحنفية أنه فاسد(4). وقد أجمع الفقهاء على تحريم بيع الثمر على النخل بالتمر في غير العرايا، وأجمعوا أيضاً على تحريم بيع العنب في الكرم بالزبيب(5)، وإنما رخص الشارع من المزابنة فيما دون خمسة أوسق لحاجة الناس. فإذا كانت شبهة الربا محرمة للعقد، ومفسدة له؛ فإن حقيقة الربا الموجودة في أسهم الشركات التي تودع، أو تقترض بفوائد ربوية أشد حرمة وأقوى بطلاناً. الدليل السابع: أن يد الشركة على المال هي نفس يد المساهم، فأي عمل تقوم به فهو عمله لا فرق بينهما؛ فكما يحرم على الإنسان أن يستثمر جزءاً من ماله - ولو يسيراً - في معاملات محرمة، فكذا يحرم عليه المشاركة في شركات تتعامل بالحرام؛ لأن المال المستثمر هو ماله عينه(6). ويتأيد هذا الدليل بأمرين: الأمر الأول: أن الشركة فيها معنى الوكالة، والشريك وكيل عن صاحبه في التصرف؛ فتصرف الوكيل يقع للموكل نفسه. وعلى هذا: فإن مجلس الإدارة يعتبر وكيلاً عن المساهم في التصرفات. فإن قيل: إن المساهم لم يفوض مجلس الإدارة بذلك، ولم يرض بهذه التصرفات، وقد يكون في المجلس من لم يرشحه المساهم. فالجواب: إن المساهم بقبوله المساهمة بالشركة قد فوض مجلس الإدارة، ووكلهم في التصرف بالمال؛ لأن هذا الأمر مشروط في لائحة الاكتتاب(7). الأمر الثاني: أن من المتفق عليه أن الشركة لو كانت بين اثنين، فيحرم عليهما المتاجرة بالربا ولو كان يسيراً، والبقاء في هذه الشركة يعتبر محــرماً؛ فكذلك إذا زاد عــدد الشركاء؛ إذ لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو مئاتٍ أو آلافاً. * الترجيح: من خلال استعراض أدلة الأقـوال الأربعة يتبين للباحث ما يلي: أن القول الأول والثاني يتوجه القول بهما بالشروط الآتية: 1- إذا لم توجد شركة مساهمة لا تتعامل بالربا إيداعاً واقتراضاً؛ حيث كانت جميع شركات السوق مما يتعامل بالربا. وهذا الشرط منتفٍ في هذا العصر حيث أثبتت الدراسة التي أجراها الباحث(8)، أنه توجد شركات مساهمة معاملاتها حلال بالكامل، ومما يؤيد هذا الشرط أن الهيئة الشرعية للراجحي ذكرت في قرارها رقم (485): «إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة؛ فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك». 2 - إذا كان نظام الدولة يجبر الشركات أن تودع جزءاً من أموالها في البنوك الربوية ويجبرها أيضاً على أن تدخل الفوائد ضمن أرباح المساهمين. وهذا الشرط حسب علمي غيرموجود في هذا العصر، لانتشار البنوك الإسلامية، ومن ثم انتشار المعاملات الإسلاميةالمصرفية. 3 - أن لا تجد الشركة بُدّاً من إتمام عملياتها إلا عن طريق الاقتراض بالربا. وهذا الشرط منتف في هذا العصر؛ إذ وجدت بنوك إسلامية تمول الشركات بالطرق المباحة: كالمرابحة، وعقود الاستصناع، والسلم، والمشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، وغير ذلك مما جاءت شريعتنا بإباحته. ثم إن المتأمل في القول الأول والثاني يجد: أن القول بهما كان في فترة فشا فيها الربا، والبنوك الإسلامية لم تقم بعدُ على ساقيها، أما في هذه المرحلة فالأمر عكس ذلك، فنحمد الله ـ عز وجل ـ على انتشار هذه البنوك الإسلامية في أنحاء الأرض؛ فأيهما أسهل: تحويل بنك ربوي إلى بنك إسلامي، أم تحويل شركة تتعامل بالربا إلى شركة خالية من ذلك؟ لا شك أنه الثاني. فالذي يظهر للباحث رجحان القول الرابع، وهو حرمة المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحاً، وتتعامل بالفوائد أو بغيرها من المعاملات المحرمة، لعموم الأدلة الشرعية في تحريم الربا قليله وكثيره، فلم تسـتثن تلك الأدلة ما كان تابعاً أو مغموراً أو يسيراً. *************************************** منقول من مجلة البيان الكاتب / الشيخ/ خالد الدعيجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|
|

|
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|